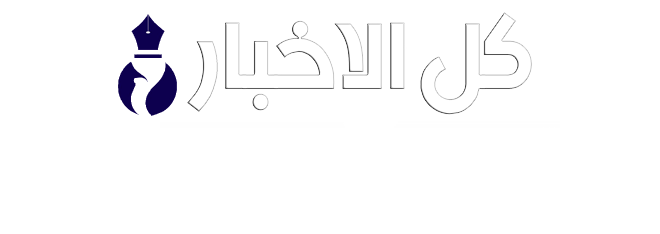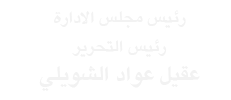مشعل التنوير... ومعوقات حمله
19-يونيو-2022
 الدكتور علي نسر- لبنان
الدكتور علي نسر- لبنانحين قرأت مقالًا للكاتب (أحمد الصرّاف) في جريدة القبس الكويتية تحت عنوان (من سيأتينا بمشعل التنوير) شعرت أنّ هذه الصرخة اللوثرية ترشّ الملح على جراحنا لتنكأها وتكويها. ملح من مملحة عربية عامة على الرغم من حصر الكاتب موضوعه في إطار كويتي، لكن المجاز المرسل يوفّر لنا فرصة ذكر الجزء والمراد الكل... فما يحاول أن يسلّطه الكاتب من ضوء على سبات في إطار جغرافي عربيّ معيّن معتمدًا وصايا (كانت)، من السهل تعميمه على أقطارنا العربية عمومًا، وكشف عورات الجسم العربي وأدران التبعية التي أصبحت عصية على الاستئصال على الصعيد الفكري والديني والثقافي والفني عمومًا والأدبي خصوصًا...
لم يستفق العرب بعد من فجيعة سؤالهم المتزامن مع مجيء حملة بونابرت إلى مصر، السؤال الذي ولّد لهم جرحًا نرجسيًّا حين كان سؤالا مغايرًا إن قارنّاه بأسئلة الشعوب الأخرى، إذ تردّدت أصداؤه المفزعة: لماذا تقدّم الغرب وتأخرّنا نحن، في حين اقتصر سؤال الآخرين على عبارة: لماذا تقدّم الغرب ولم نتقدم نحن... هذا الشعور بالتأخر مرده إلى رؤية الذات العربية عبر مرآة الغرب، وجراء وجع الجرح النرجسي، التفتت الشريحة الأكبر من النخب والجمهور وما زالت ملتفتة إلى الماضي السحيق كحصون منيعة يمكن أن تقينا من محاولات الآخرين طمس هويتنا وديننا وثقافتنا، حتى استحال معظمنا أقرب إلى السلاحف التي تخبّئ رؤوسها تحت صدفة تعتقدها من ضروب الحماية، عندما تشعر بحركة حولها فتقف مكانها وتتجاوزها تلك الحركات التي أقنعت نفسها أنّها خطر لا بد من درئه عبر الاختباء.
وهذا الاختباء/ التبعيّة، ضربٌ من ضروب الراحة والسكينة، لأنّ التغيير وخرق المألوف أمر محرج يتهدد الكيان القائم الفعلي الذي أنتجته ظروف كأعمدة ترفع كتلة إسمنتية، تبقى الكتلة متحجّرة وإن تقوضت الأعمدة التي ترفعها كما يعبّر ألتوسير... وبهذا تنهزم المتغيرات لصالح الثوابت وتتلاشى فرصة التفكير بما يعرف بالوعي الممكن المحفّز الأساس على رؤية التغيير حسب لوسيان غولدان... كل هذا نتيجة اتخاذ الشكل نهائيًّا متناسين أنّ الشكل يحوي مواد لا تشبهه وفي أي فرصة يمكن أن تتمدد وتهدم الشكل الذي أوهمنا مقدّسوه أنه عصيّ على الهدم والتقويض... وهذا ما عانت منه أوروبا سلطويًّا وفنيًّا حيث الكلاسيكية التي هيمنت قرونًا ولم تتصدع إلا على ضربات الثورة التغييرية التي تمثلت بالرومنسية على الصعيد الفني... وكذلك عند العرب، حيث تحكّمت نظريّات نقدية ذات معايير خارجية وأخلاقية ودينية بالنصوص الأدبية فكانت أشكالًا نهائية تتماهى مع أشكال الحكم المستمد من السماء وكل محاولة للتغيير يعد شبهة وفوضى ويتهم أصحابه بأنّهم ممسوسون بقوة شيطانية أو بعطب أصاب عقولهم وأرواحهم منذ أفلاطون مروروا بالمعتزلة وإبن رشد ثم قول هيغل (كل ما هو عقلاني واقعي) وصولًا إلى اليوم وما يعاني منه الفكر العربيّ حسب مقال الأستاذ الصراف من تبعية تعدّ ترجمة لمقولة (الحق قديم) و(لا تقس الأمور على مقدار عقلك فتكون من الهالكين)، فرُحنا نشيّد صروحنا على هياكل قديمة غير مستقلة وهذا سيؤدي إلى الانهيار طالما أن التفكير في المستقبل عبر الخيال العلمي تطاول على الله، والسير على منوال الأقدمين منجاة، وهنا نستذكر ما قاله أبو نواس ساخرًا من تبعيّة الشعراء العمياء في ظل متغيرات حياتية فرضت نفسها:
تصف الطلول على السماع بها/ أفذو العيان كأنت في الفهمِ
وإذا وصفت الشيء متّبعًا/ لم تخلُ من زلل ومن وهمِ.